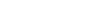مقاهي السوق المركزي وخطّاطه
ليست الوجوه وحدها التي لم تبلَ؛ المكان نفسه، المؤثث بتلك الوجوه وأنفاسها، لم يزل طريًّا فيها، كأن الأيام نقشتها بالأمس فقط في الذاكرة، وليس قبل ما يقارب النصف قرن.
(1) "صالح ماوية" ومقاهي المركزي
لم يكن في الشارع الرئيس للسوق "مقهى" بالمعنى المتعارف عليه، لكن كان على الرصيف الضيق بجوار دكان "أحمد إسماعيل" صندقة حديدية، محاطة بصناديق وعوارض خشبية، يستقر فوق سطحها "دافور" سويدي أصفر (موقد البارافين) وأكواب زجاجية، وفي خزانتها السفلية توضع المؤن من سكر وشاي وبُن و"حوائج" (بهارات)، وبجوارها استقرت بعض الأواني البلاستيكية المتوسطة لحفظ الماء.
مالك "الصندقة" (محل من الصفيح)، كان شخصًا نحيلًا بسيقان متهتكة بالدوالي، يرتدي على الدوام ملابس شعبية بسيطة، تغطي مقدمتها مريلة زرقاء بالية، ينتعل، باستمرار، حذاءً رياضيًّا، مثل تلك التي ينتعلها لاعبو كرة القدم في الحواري. كان يُعرف بصالح، ويلقبونه بـ"ماوية"، نسبة إلى المنطقة التي ينتمي إليها في أرياف تعز الشرقية. كان، حين يُستفزّ بقصد المزاح غالبًا، يتحول إلى لسان لا يكفّ عن "العرعرة" والشتم. كان أيقونة حيَّة في السوق، فالشاي الذي يحضِّره في" الكتالي" (الأباريق) العتيقة كان مختلفًا ولذيذًا، رائحة تحضيره كانت تُضمِّخ المكان، وتستدعي إليها كلّ مارٍّ بقربها، وكان حين يغادر إلى قريته بعد أشهر، من المكابدة، يفقد السوق أحد معالمه، ولا يستطيع من ينوبه ملء فراغه المحبب.
لم نكن نراه هادئًا مبتسمًا سوى في فترة ما بعد الظهر، أثناء تناوله للقات على الرصيف. كان سريع الانفعال من أبسط المواقف، وكان كل من يعرفه يُرجِع الأمر إلى إصابته المبكِّرة بالسكر، لكن ما كان يجعل الناس يحبونه ويمازحونه هو جودة صنعته، ولسانه الشتَّام بطريقة أهل "ماوية" المحببة "بن بَمْبَات...".
صار اسمه مرتبطًا بكل من يمتهن بيع الشاي والقهوة في المحيط، وأتذكرُ أحدَ أهل قريتنا، أنشأ بالقرب من مجرى السيل في حي "الضبوعة" "صندقة" لبيع الشاي والبن، وكان زبائنه من بائعي الخضروات في الجوار ينادونه بـ"صالح".
قبل أن يُهدم الجزء القديم من السوق لتشييد مبنى البلدية المتجهم بطلائه الأسود، مطلع الثمانينيات، كان هناك من يبيع الشاي والقهوة، في إحدى البسطات، بطريقة مختلفة عن "صالح ماوية"، وبصورة أقرب إلى تحضيرها الريفي، وخصوصًا "القِشْر"، كان لقبه "الأصوع"، قصير القامة بوجهٍ مجدور هادئ ومبتسم. انتقل بأدواته إلى "صندقة" حديدية صغيرة في سوق الدواجن، وبقي بها سنوات طويلة، وكان من لا يعرف اسمه يناديه بـ"صالح" أيضًا.
أما المقاهي التي على طرازها الحديث، فقد كانت تتمركز في محيط السوق؛ ففي نهاية الزقاق الذي يمر جوار مبنى البلدية والمسلخ، ويطل على شارع التحرير الأعلى، كان يقع مقهى "الذماري" بديكوره الأخضر اللماع ورفوفه الخشبية، التي كانت تتزين بعلب العصائر. كان يُباع، في المقهى، إلى جانب الشاي والبن المحلَّب، "سندويتشات جبن الكرافت والمربى"، والعصائر الموسمية، التي تُستبدل بما هو معلَّب حين ينتهي الموسم، على نحو استخدام المانجو الهندي المعلَّب بديلًا عن مانجو "البركاني". وبالقرب من هذا المقهى كان هناك مقهى "حميد شاهر الشيباني" الذي ظل يُقدِّم الخدمات نفسها لسنوات طويلة.
أسفل عمارة "صالح ناجي" الحديثة التي بنيت بالحجر الأحمر والأخضر من جهة الجنوب، وبجوار مكتب وكيل المغتربين "أحمد محمد بغلف"، كان هناك مقهى بمواصفات حديثة، يقدم الخدمات نفسها. كان اسمه مقهى وكفتيريا "بيليه"، ويتزين مدخله من الجهتين بلوحتين خشبيتين بالنمط ذاته وألوان فاتحة متداخلة لاسمه العجيب، والذي اختاره مالك المقهى في ذروة مجد اللاعب البرازيلي الأشهر عبر التاريخ. ما كان يميز هذا المقهى هو تقديم الشاي "الليبتون" و"السندويتشات"، ولاحقًا خبز الطّاوَة. كان لي صديق وزميل دراسة وديع يعمل فيه اسمه "عبدالمولى"، لا أعرف أين حطت به الأيام. أتذكر أننا كنا، بعد شرب الشاي "الليبتون"، أو نجد بعض مخلفاته على الطاولة، نمسك بخيط الكيس ونرمي بقاعدته إلى الأعلى على أقرب سقف أسمنتي لبلكون أو شُرفة، والفائز هو من يلتصق الكيس برميته، ويبقي طابع الشاي يتدلى من الخيط لأيام.
كنت أستغرب من لوحة أشهر مطعم للفاصوليا، كان يقع بالقرب من "جامع السقّا" في امتداد شارع السوق، إذ كانت تُسمِّي المحل بـ"مقهى ومطعم سبأ". مالك هذا المطعم "شمسان أحمد المعمري"، الرجل المميز بهيئته ولسانه الفَكِه، وذاكرته المتقدة في حفظ أسماء الزبائن. كان صديقًا للجميع، ولا يرد جائعًا أو عابر سببيل.
كنا نذهب إلى الجامع لصلاة العصر، ونبقى نستذكر دروسنا، حين كنا طلابًا في مدرسة التحفيظ الصباحية، ولما كانت تدخل من نوافذ الجامع روائح تحضير الفاصوليا، أسفل المسجد، كنا نعرف أن الوقت صار يقترب من المغرب، وعلينا المغادرة إلى الدكان.
كنا حين نطل من نافذة المسجد نرى في الزقاق رجلًا مسنًّا، سمين الجثة بلكنة عدنية، ظل يعمل في المطعم منذ الخمسينيات، منذ كان يعمل مع الأب في مطعم "بُريقة عدن". كان وحده من يشرف على المواعين النحاسية الكبيرة "الجِحَل"، التي تُنضِج الفاصوليا الحمراء المميزة، ويأتي لتناولها زبائن المحل من أرجاء المدينة. وحتى سنوات قليلة كان المطعم -مطعم شمسان، حسب التسمية الجارية في الألسن– لا يزال يقدِّم خدماته لرواده من الفاصوليا الحمراء، وفي منتصف السبعينيات كان المطعم الوحيد في الحي المتخصص بعمل "المُطَبّقية" العدنية برائحتها الزكية.
أسفل عمارة "الشيخ الجهمي" لجهة الشارع الموازي للسوق، كانت هناك مقهاية "العبسي"، يبيع صاحبها إلى جانب الشاي، خبز الطاوة، وكنا كثيرًا ما نذهب إليها في العصاري، لتناول الخبز مع الشاي الحليب، منجذبين إلى رائحة الزيت التي تنبعث مصاحبة للدخان، حين يقلَّب العجين على الصاج الثقيل المدور.
هذه المقهاية كانت غير مخبازة "أمين العبسي" المشهورة، التي تقع بالقرب منها في الشارع الضيق الموازي لشارع السوق، والتي تعمل لفترتي الصباح والظهيرة فقط، وكانت تقدم لزبائنها الوجبات الشعبية، من اللحوم والأسماك والفتّة و"الصانونة"، وصارت تاليًا من أشهر المِخبازات في تعز، وتفوّقت على مخبازة تقليدية أخرى مجاورة لها في السوق تعرف بـ"مخبازة الجُليحي"، التي اشتُهرت لسنوات طويلة ببرم اللحم المطهي على الفحم. في سنوات لاحقة نشأت على تخوم السوق مخبازات جديدة، تخصصت بتقديم وجبات الأسماك، والخبز و"سحاوق الجبن" التي تُجلب من السوق القريب.
(2) الخطاط شكري
لا يمكن الحديث عن تفاصيل السوق المركزي، المؤثث بالوجوه، دون الحديث عن الخطاط "شكري". فأنا لم أعد أتذكر "علي شكري زيوار" الأب، وهو المؤسس الأول لمحل الخط في الشارع الخلفي للسوق بالقرب من سينما "بلقيس"، لكني أتذكر جيدًا ابنه "محمد علي شكري"، لاعب نادي الطليعة المميز الوسيم، ورئيسه لاحقًا، وهو الذي كان يدير المحل أثناء لعبه للنادي وبعد اعتزاله. أتذكر اللافتات القماشية الزرقاء والحمراء التي كانت تعلق على الجدران القريبة، ليجف حبرها، قبل نقلها لتعليقها في تقاطعات الشوارع وعلى واجهات المؤسسات الرسمية وفي مداخل المدينة، مبشّرة بقدوم الأعياد والمناسبات أو الترحيب بالضيوف.
ينحدر "محمد علي شكري" من أسرة فنية معروفة، فجده لأبيه "شكري زيوار" كان خطاطًا ونحّاتًا مشهورًا. وهو الذي خطّ المصحف في جامع الملك "المظفر"، في مدينة تعز. كما أن والده "علي شكري" هو الذي قام بتزيين قباب الجامع ووضع التصاميم لبعض العملات في ذلك العصر
كان الخطاطون الذين يعملون معه في المناسبات الكبيرة يستغلون الأرصفة الأسمنتية بين العمارات والبيوت، ويفرشون عليها الأقمشة الملونة، ثم بفراشي عريضة يغمسونها في عُلب الرنج الفضي والأبيض والأحمر، يقومون بكتابة الشعارات والعبارات التي ينقلونها من دفاتر وأوراق أمامهم. أي خطأ كان ممنوعاً، لهذا كانوا يكتبون العبارات بحذر بعد تهجي الكلمات وتشكيلها، وإلا خربت الأقمشة، وكنت ألحظ بعضهم يقومون بإزالة الأخطاء المتداركة الصغيرة بمادة فعالة مزيلة للرنج، ثم يعيدون تصحيح الخطأ بعد طلي البقعة المشوهة بلون القماش نفسه بكتابة الكلمة أو الحرف الصحيح، وكانت هذه العملية، وقبلها رسم الكلمات، تشدني طويلًا، وكنت حينما أخلو بنفسي في الدكان أقوم بتقليد خطهم على ورق الحليب المقوى. ذات الخطاطين كنا كثيرًا ما نراهم على السلالم وهم يخطُّون لوحات المحلات، أو يركّبون لوحاتها الخشبية المزينة بالنيون واللمبات الملونة على الواجهات، بمساعدة عمال مهرة.
معظم محلات السوق ومحيطه ومحلات كثيرة في المدينة، كانت توقّع لوحاتها الخشبية المعلقة في واجهاتها، وكذا المكتوبة على السواتر الحديدية التي تربط ظلف الأبواب من الأمام، باسمه المميز؛ "شكري". كنا نحن أطفال المحيط، نتباهى بخطه وبمجاورته، فقد كان الفارس الأهم بمجاله، ولا ينافسه إلا خطاط كان يوقع باسم "الشميري"، وقبله كان هناك خطاط يوقع باسم "نوفل".
يقول عبدالرحمن بجاش: «أينما تذهب بنظرك، فثمة "شكري" الأنيق؛ خطٌّ يجمل عينيك بأجمل خط. "شكري" احتل تعز أجمل احتلال، ولفترة هي أجمل مراحل عمرنا، ضُرِبَت أيادينا بعصي آبائنا؛ إصرارًا على أن يكون خطّنا مثل "شكري"!!، وكيف لنا أن نكون مثله، والمسألة تتعلق بالموهبة؟!».
قيل إنه استدعي إلى صنعاء منتصف الستينيات ليرسم شعارات القوة الجوية على طائراتها المقاتلة، وهو لم يتخطَّ الخامسة عشرة، وتاليًا قام بتنفيذ عدد من المجسمات العسكرية للقوات المسلحة، بما في ذلك تمثال الأستاذ محمد محمود الزبيري، وتمثال الرئيس عبدالرحمن الإرياني، وتمثال الجندي المجهول، ولاحقًا كانت عربات الاحتفالات في أعياد الثورة والعمال تحمل بعض مجسماته الخشبية والإسفنجية، وهي تصعد العقبة في طريقها لميدان الشهداء في العُرْضي.
صار محل الخطاط والرسام "شكري" الصغير، محلًّا واسعًا في الجوار منذ منتصف الثمانينيات، قبل أن يصير مؤسسة إعلانية كبيرة، لها أجهزتها ومعداتها التقنية ولها فرعها الكبير في عدن. استبدلت الأنامل الذهبية للفنان وصحبه، وخشبهم وإسفنجهم ولوحاتهم القماشية الملونة، بالجرافكس وتقنيات الخط الإلكتروني واللوحات الحرارية والبَنَر والبلاستيك المقوى. الفنان "محمد علي شكري" لم يزل بأناقته التي عهدتها به قبل أربعين عامًا، ولم يزل جسده النحيل يحمل الكثير من وسامته الشابة ورشاقته.
نقلا عن منصة خيوط