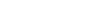الأجينات.. المقبرة الأشهر، ذات العمق التاريخي المُوغل في قلب الحالمة تعز، المُزدحمة برفات أجيال دخلوا الموت من بابه الأصعب، فلم يبوحوا بعد بمرارة التجربة، ما إن ولجت بوابتها حتى سارعت بديهتي بقراءة المثاني السبع، والدعاء بالغفران لكل الموتى المطمورين تحت أديمها المتماسك، ثمة فيض من العبرة المطحونة بالندم شدني، جذبني إلى ذلك الركام، وفي المقابل ثمة مفاتن دنيوية لم تلبث تحاصرني، تطمئنني بأنَّ دورك لم يحن بعد.
أمام تلك التجاذبات سمحت لنفسي بالإيغال أكثر في تفاصيل الموتى، قرأت بجلاء تاريخاً من النهايات المُختلفة، تتباين فيه الأيام والأشهر والأعوام، إلا أنَّ ولعي بالتواريخ طغى على رهبة الموت، لم أعد أتخيل صاحب القبر كيف جسده الآن، بل كيف كان ماضيه قبل تاريخ نهايته المحتوم؟ كانت (الأجيناد) أو (الجنينات) كما هي تسميتها السابقة، أو (الأجينات) كما هي تسميتها الحالية، كانت إبان الحكم الرسولي إحدى ضياعهم المُترعة بالخضرة والجمال، ولأهميتها؛ كونها قريبة من قصورهم الشاهقة، ومقار دولتهم الفتية، جعلها المُظفر يوسف من صداق زوجته (الزليخا)، التي حلمت أثناء نومها بحشدٍ كبير من الناس يلجون فرجها (مَخرج الولد)، ولفظاعة الرؤيا، وغرابته، أرسلت إلى الإمام الأسير إبراهيم بن تاج الدين الذي بدوره طمأنها، وأخبرها بأنَّها ستوقف أرض الجنينات صداقها المعلوم، وتجعلها مقبرة لفقراء المسلمين إلى يوم الدين، وبأنَّه سيكون أول من يدفن فيها. الحكاية هنا نثرتها كما ترددها الذاكرة الشفهية، وهي إلى حد ما مقبولة، وإلا لما تناقلتها الألسن، وحفظها العوام. الأجينات اليوم مسكونة بموتى بلا حصر، شواهدهم مُتناثرة على امتداد البصر، و قبارين هم كما يصف أحدهم عائشين بين الحياة والموت، فيما هيئتهم تفصح عن أشباه أشباح بأجساد كالحة، لم ينفض عنها حتى غبار الموتى.
في البدء التقيت الحاج سيف محمد سعيد ـ 85 عاماً ـ كبير القبارين ومسئولهم المباشر، وأحسنهم حالاً من حيث المظهر والاستقرار العائلي، فهو متزوج وأب لستة أبناء، وعلى تواصل دائم بهم وبغيرهم، وصل إلى عمله هذا توريثاً، وهو دائماً ما كان يتردد عليها في فجر شبابه، ليمارس مهمة آبائه وأجداده، ويساعدهم باقتدار. قال الحاج سيف بأنَّ مقبرة الأجينات لم تكن بهذه المساحة المحصورة داخل هذا السور ـ يقصد سورها المستحدث ـ فهي كانت أكبر من ذلك، ولم يتبق الآن سوى نصفها الجنوبي، مستشهداً بأن غالبية المنازل والشوارع المجاورة قامت على أنقاضها.
في قلب المقبرة، استوقفتني غرفة صغيرة (دُشمة) كما هي تسميتها في اللغة الدارجة، يطوف عليها حشد كبير من الكلاب الضالة، رغم ذلك العائق قررت الاقتحام، فإذا بي أقف أمام عجوز كهل مستلق بجانب تلك الغرفة، يدعى محمد الزعيل، عمره 80 عاماً، النصف من ذلك قضاه في دهاليز هذه المقبرة قادماً من بلاده آنس محافظة ذمار، فلا زوجة ولا ولد ولا شيء من هذا القبيل، حتى العقل بلا شماتة غير موزون. داخل تلك الغرفة (الدشمة) ينام سليمان محمد سعيد، حاولت جاهداً إيقاظه من نومه العميق، أو موتته الصغرى، لأتفاجأ أن حاله - كما تحدث لاحقاً ـ لا يختلف عن الزعيل، وإنْ كان أصغر منه بسنوات قليلة، إلا أنَّ عمره المهني في هذه المقبرة تجاوز الـ 47 عاماً، وهو الآخر صلته بالعالم الخارجي محدودة، فأهله وزوجته وخلانه هي هذه المقبرة ولا شيء سواها. قيل لي ـ مسبقاً ـ أن مقبرة الأجينات تحولت إلى مرتع خصب للمتسكعين ومحببي الديزبام، وسكارى الأسبورت، وقناني الديتول، وإن كنت أثناء جولتي الاستطلاعية قد لا حظت بقايا تتناثر هنا وهناك، إلا أنها - واقعاً - لا تؤكد ما قيل؛ لأن ما وجدته لم يتجاوز بقايا أعواد القات، وعلب السجائر الفارغة، وما خفي يعلمه الله.
رغم ذلك، الشكوك لم تفارق مخيلتي، ولتفنيدها أو تأكيدها التقيت بالأخ نديم الذبحاني، حارس المقبرة المعتمد من مكتب الأوقاف في المحافظة، الذي بدوره لم يفند تلك الشكوك؛ لأنها كانت موجودة ومعاشة من قبل. وبالنسبة للحال اليوم، فهو حسب وصفه مختلف للغاية، وتغير إيجاباً بصورة بات يلحظها الجميع، نديم قال إنه يصادف أثناء عمله مجموعة من أولئك المتسكعين إلا أنه يتعامل معهم برفق، فهو ليس لديه سلاح ناري أو أبيض، لأن الكلام الحسن هو سلاحه؛ وقد أثمر، والواقع حسب توصيفه يشهد. طلبت من نديم أن يحدثني بأبرز موقف حدث له خلال عمره المهني مع أولئك المتسكعين أو سواهم، فأجاب بتكتم: "استر ما ستر الله"، وهي العبارة التي ولدت في رأسي ألف سؤال وسؤال، ورغم إصراري الشديد وسعيي لكشف المستور، إلا أن صاحبنا نديم أبى واستعصى أن يبوح بأي شيء.
نديم أخرج نفسه من ذلك المطب الذي أدخل نفسه فيه، إلى حديث آخر عن أناس يزورون المقبرة في أوقات متقطعة، أسماهم بـ (الضباحى)، فهو ما إن يبادر بسؤال أحدهم عن سر تواجده، حتى يباشره الآخر بعبارة "أسألك بالله خلي لي حالي!"، وأضاف: "زيارة المقبرة تزيل الهم والحزن، وتجعل المكروب ينسى همه، فهو يبوح بأسراره للموتى الذين إن سمعوا كانوا خير كاتم، والمقبرة تضفي على زوارها مزيداً من القناعة، والروحانية، وتكشف قبح الدنيا وحقارتها، وأنها لا تساوي شيئاً". يؤكد المسئولون على مقبرة الأجينات أنها تستقبل الموتى من عهد الدولة الرسولية، والمُلاحظ خلو أضرحتها القديمة والمقضضة من تواريخ الوفاة، والذي أثار استغرابي وجود أحد تلك القبور مهدماً، وأيادي النبش قد دخلت في عمقه كثيراً، حينها سألت الحاج سيف بأنَّه مُتهم وزملاؤه بنبش القبور القديمة واستبدالها بقبور جديدة؟!، سؤالي الاستفزازي لم يكن بسيطاً عند الحاج سيف؛ بل تهكم على من يقول مثل هذا الكلام، مضيفاً بسخرية: "المقبرة أولاً وأخيراً كبيرة، وهناك مساحات منها غير مستغلة، فأشجار التين الشوكي مُسيطرة عليها، وهي بحاجة إلى الاستغلال الأمثل، وهذا العمل المشين لا يقوم به حتى الكافر".
ودعا الحاج سيف مكتب الأوقاف إلى زيادة الاهتمام بمقبرة الأجينات، وتوفير متطلبات القبارين، وتوظيفهم، ولو حتى برواتب رمزية، وإكمال تسوير المقبرة، وسد الثغرات المستحدثة، وتخليص الأراضي المجتزأة منها نهباً من بعض المتنفذين. وخلص إلى أنَّ حرمة المقابر اليوم صارت منتهكة، والواجب أن تتكاتف الجهود في سبيل الحفاظ عليها، دون إهدار لرفات المدفونين تحت ترابها. - فقرات من استطلاع طويل، نُشر في صحيفة (الجمهورية) قبل 11 عاماً، 1 يوليو 2010م.